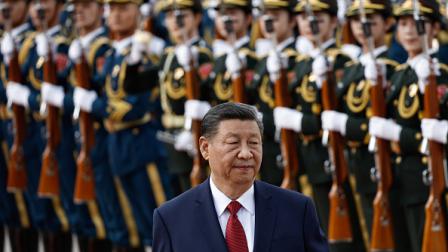تبدي السلطة الفلسطينية، ما تظنه براعة كبيرة في التستر على استمرار تنسيقها الأمني مع دولة الاحتلال وأذرعها الأمنية. وهي تقوم بذلك من خلال فيض التصريحات "المحاربة" التي أصدرها رئيسها، محمود عباس، في إظهار الغضب الفلسطيني، الرسمي من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومحاولة تجنيد الدعم الدولي للمواقف الرافضة لترامب والتغني بالقرارات الأوروبية المعارضة لتصريحات ترامب، فيما تتيح المجال لفتح الطرقات أمام قوات الاحتلال لانتهاك البلدات والمدن الفلسطينية سعياً وراء عناصر المقاومة، من دون أي معارضة من أجهزة الأمن الفلسطينية، رغم تغني هذه السلطة بالمقاومة والشعبية السلمية.
وتمثل منظومة هذه الأجهزة بعقيدة "التنسيق المقدس"، حالة فريدة في تاريخ حركات التحرر الوطني، لكونها الوحيدة التي تقوم بها قوات "الثورة" أو السلطة التي تمثل الشعب الواقع تحت الاحتلال، بالتصرف وكأنها تمثل منظومات أمن داخلي لدولة كاملة السيادة، تقوم بحماية لنظام، لكن من دون أن توفر في المقابل أي حماية للوطن والشعب من أعدائه الخارجيين، وفي هذه الحالة الاحتلال الإسرائيلي.
ولعل ما يزيد من حدة المفارقة الخاصة بهذه الأجهزة، هو نعتها بأجهزة الأمن الوطنية، من جهة والتفاخر بدورها في خدمة الاحتلال لجهة ضمان الاستقرار والهدوء ومنع العمليات الفدائية في الأراضي المحتلة. ويتجلى هذا الأمر أيضا في عدم اعتراض الأجهزة الفلسطينية لأي من قوات الاحتلال حتى عند اقتحامها لمدن يفترض أنها في المنطقة (أ) تعود الصلاحيات الأمنية فيها للسلطة الفلسطينية.
لكن واقع الحال في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) وبعد استشهاد أحمد جرار واقتحام قوات الاحتلال لنابلس وقتل الشهيد خالد تايه، وسقوط 14 شهيداً منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، يشير إلى أن هذه الأجهزة لم تعد أكثر من أجهزة قمع للشعب الواقع تحت الاحتلال لتثبيت بقاء سلطة لا تملك من أمرها شيئاً، ويحتاج رئيسها، قبل خفيرها لتصريح مرور وتنقل من أصغر جندي إسرائيلي على حاجز عسكري عند مشارف رام الله.
لم يعد هناك متسع بعد أحداث نابلس واليامون، (تصفية أحمد جرار، وقتل الشهيد خالد تايه)، لمواصلة التنكر للحقيقة الساطعة بأن التنسيق الأمني مع الاحتلال، هو تنسيق قاتل يفتك بأبناء الشعب ويشل قدرة الشعب على المقاومة ومواجهة الاحتلال.