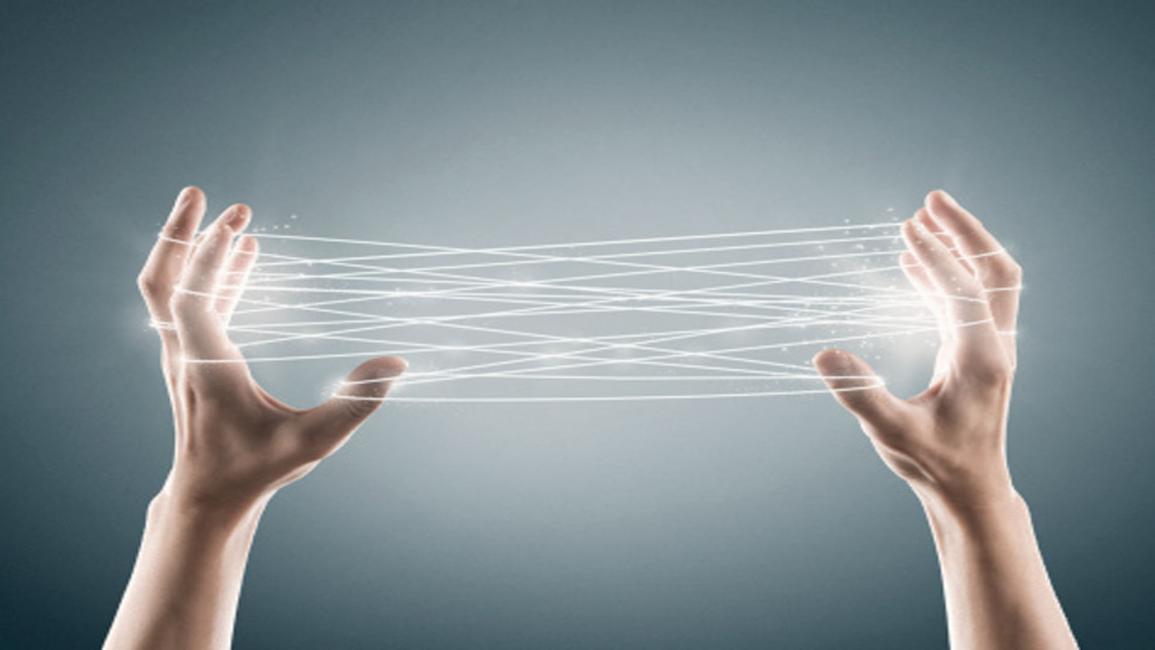استراحة من المجال الافتراضي
يمكن أن تزيد النقاشات الافتراضية من توتر الأعصاب (Getty)
عملٌ مضنٍ وممتعٍ في الوقت نفسه هذا الذي كان يُجبر "أحدنا" على النشاط الفكري والحركي في سعيه الدؤوب إلى إنتاج ما يتمنى أن يُقرأ، وما يأمل أن يجلب الاهتمام، وما يسعى إلى أن يحظى بالإعجاب. وكان ارتياد الأماكن العامة من مقاهٍ إلى مكتبات إلى تجمعات، حين كان ذلك ممكناً في زمن الاستبداد، له دورٌ أساس في إغناء التفكير وتحفيز التعبير. فهل استمر الحال في زمن المُحال؟ وإن لم يستمر، فهل استُعيض عنه بما يُغني ويُفيد؟
بعد أن كان واحدنا، ولا أستثني منّا أحداً، يرجع إلى البيت أو المكتب حاملاً فكرة ما سيكتبه ومتأثراً بما عاش، أو قرأ، أو سمع، أو ناقش، صار غالبنا من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعي، المُفسْبَكُ منها أو المُتَوْتَر. وصار جُلّ اهتمامه منصباً على متابعة الجمل القصيرة الواردة من هنا ومن هناك، أو المشاهد المصورة الحافلة بالمؤثرات البصرية والصوتية، أو المشاركات المتنوعة التي لولا هذه الوسائط، لما كان له أن يمر بها أو أن تمر به.
في عرض هذا كله، لا إدانة لأي فعلٍ، ولا أحكام قيم لأية ممارسة، ولا محاكمة للنيات بخصوص أي اختيار. هي محاولة لفهم تطوّر المصدر ومآل التحليل. ولا عيب في أن تتطور الوسائل والطرائق، ولا ضرر في أن تتنوع المصادر وتتوسّع. فهذه الوسائط الحديثة، تحمل الخبر الجديد في كل لحظة، منه المؤكد وكثيرٌ منه المفبرك. وهي، أيضاً، تعكس تجلّيات بعضهم الفكرية والروحية والضميرية. كما أنها تحمل جرعات من "فشّات الخلق" والشتائم المَرَضيّة والمُرْضية لبعض المُقنّعين بالتقوى والباحثين عن زوايا مظلمة، يُفجّرون فيها كبتهم الأخلاقي.
فإن استعر الكلام الطائفي، انبرينا إلى الكتابة عن الطائفية، وإن تجاذبت العصبيات القومية المُفَسْبكين، تطرّقنا إلى التقسيمات القومية ومآلاتها. إن شتم أحدنا أحدهم، انقسمنا بين مدافع عن المشتوم ومتضامن مع الشاتم، واجترعنا نصّاً أدبياً يُعبّر عن موقفنا من التشاتم القائم، أو حللنا نفسياً موقف الشاتم والمشتوم وما بينهما. أما إن تقاسم أحدنا/أحدهم صورة أو مقطعاً مصوّراً، فنصير نُقّادًا فنيين، أو محللين "استراتيجيين"، للصورة وللمقطع. أما إن كان المُتقاسم أغنية، فتتطور ذائقتنا الشخصية لتصبح اختصاصاً موسيقاتياً، وتنبري أقلامنا لخطّ المعلقات النقدية أو المدحية. وفي حالات عدة، نخوض معارك كلامية، نؤازرها بمقالات طويلة، بناءً على فكرة/جملة/صورة/مقطع/أغنية .... إلخ، صادفناها على صفحات التواصل الاجتماعي محمود الذكر.
ظاهرة منتشرة وليست مُدانة بالمطلق، وهي تفيد في جلب كثيرين وكثيرات إلى معاقرة الكتابة ومحاولة التعبير. وهي تساهم في دمقرطة المهنة/الهواية، بحيث يدخل في حلباتها من لم يكن لهم باعٌ أو ممارسة، ويسمح لهم بالانتقال من التعبير اللحظي إلى التطوير النصّي. هذا أروع ما تحمله من إيجابيات، لأننا نكتشف، إن كان لنا الحق في ذلك، مواهب متميّزة، بعضها يَجِبُّ كثيراً من الهامات المتجذّرة في الكتابة.
ما يمكن أن يكون باعثاً على القلق، إن صح القول، يكمن في أن يتحوّل مفكرون ومنتجو نصوص وصانعو رأي إلى الانغماس في هذه الصفحات، والغوص في رمالها المتحركة واللزجة حتى الالتصاق. ما هو مقلق أيضاً، وربما، أن يُطوِّعَ الباحثون نصوصهم لنيل ما تيسّر من إعجاب الجمهور أو حتى، أن يتنطع آخرون إلى إنتاج "ما يطلبه الجمهور". وهذا ما يمكنه أن يحمل، في ثناياه، تبسيطاً معرفياً أو تسطيحاً فكرياً، سعياً إلى إرضاء الذائقة أو التجاوب مع انتظاراتها. كما يُخشى أن تأخذ التجاذبات الفيسبوكية والتويترية الواسع من الوقت الذي يمكنه أن ينصرف، بصاحبه، إلى كتابات أعمق وأجدى. ويمكن، أيضاً، أن تزيد النقاشات الافتراضية من توتر الأعصاب غير المساعد البتة في التعمّق المعرفي.
والآن، اعذروني، فسأعود إلى المواقع إياها (...)، باحثاً عما يمكنه أن يحفزني، أو يجذبني، لأكتب عنه، و "ما حدا أحسن من حدا".