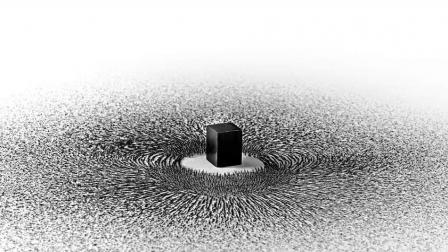نوري الجرّاح
الطريق بين لندن وليدز حبل السرّة للشاعر المنفيّ الذي يحمل حقيبته المملوءة بالكتب والقصائد وأعباء الزمن، ويرتحل بها نحو وطن القصيدة. لا شيء كالشعر يبدّد المنفى والغربة. هذا ما أثبته الشاعرُ السوريّ نوري الجرّاح (دمشق 1956) في الأمسية التي أقامها له قسم الدراسات الشرق أوسطية بجامعة ليدز في المملكة المتّحدة مؤخراً.
يظلّ الجرّاح كشاعر منفيّ كائناً معلّقاً في فضاءاته، والمنفى أحد أوردة كتابته، يرتحل عبر المنافي منذ ثلاثة وثلاثين عاماً باحثاً عن وطنه الذي كان قد أصبح بدوره منفىً له حين كان فيه.
بعد إلقاء مجموعة من قصائده الحديثة بأداء لافت، انتقل الجرّاح إلى الشعر وتاريخه ورحلة المنفى واللحظة الراهنة، وارتباط القصيدة بفكرة المنفى في حوار مع جمهور انجليزي بدا مهتماً بتجربة الجراح وباللحظة السورية التي يمثلها.
ساح صاحب "رسائل أوديسيوس" في جغرافيات متخيّلة مؤسطرة وعصور غابرة، وكيف أنّه يعيش منفى مزدوجاً بأكثر من صيغة، يكتب قصيدته بالعربيّة في شارع يصوّت بالإنكليزيّة، ولا يعرف جمهوره العربيّ لاعتبارات كثيرة، وهو قدر يتقاسمه الشعراء المنفيون.
احتلّ الحديث عن الميثولوجيا جانباً رئيساً من مداخلة الجراح، دلف من خلالها إلى التاريخ والواقع، وكيف أنّها تظلّ ـ بما تشتمل عليه من مخيّلة قصصيّة فيها غواية وإغراء ـ منهلاً ثرّاً وخزّاناً لا ينضب لتجديد دم الشعر. ثم تناول كيفيّة تأثّر الشعر العربيّ بالميثولوجيا الإغريقية، وأشار إلى جوانب الخلل في استلهام الأسطورة من قبل الشرق عبر القراءة الغربيّة لها والمحافظة على كلاسيكيّتها بعيداً عن التجديد، وأهمّية استنطاقها كرمز وقناع وتفجيرها بالمختلف والصادم بغية العبور إلى جديد مبتكر. واستشهد على ذلك بالشاعر اليونانيّ يانيس ريتسوس وتناوله للأسطورة بطريقة صادمة ومستفزّة.
وتوقف الجرّاح عند إشكاليّة تعانيها الشعريّة العربيّة الحديثة، وهي الغربة بين الشعريّة والجمهور الذي تأسّست ذائقته على أساس يتناقض مع هذه الشعريّة. كما حرص على التذكير بأهمّيّة كتابة شعر له قيمة شعريّة عالية وليس في نواحٍ أو في ميوعة عاطفيّة، ذلك أنّ للشعر كرامة وللحرّيّة كرامة بالمعنى الروحيّ والفكريّ، ولابدّ من التعبير عن معانيها وتجلّيّاتها بأكثر من صوت وقناع.
تحدّث الجرّاح عن واجبات الشاعر الحديث ومهمّاته، ولا سيّما أنّ الشاعر "محارب" في الأدب والثقافة والمجتمع، عليه رؤية العالم بطريقة جديدة تناسب خطابه عن التحديث والمرونة بصيغة لا تتّكئ على التراث وتكون عالة عليه. وذكر أنّه لا بدّ من هزّ شجرة مصادر المخيّلة التي تشتمل على كثير من الأوراق الصفراء، وتحريكها بقوّة لا تقتلعها من جذورها بل تعيد ضخّ ماء الشعر والحياة فيها.
أوجب نوري على الشعراء الانتماء إلى الحسّ الجديد والمبتكر، ملاحظاً أنّه ليس مطلوباً من الجديد أن يكون راسخاً، وذكر أنّ الكتابة الجديدة في تقدّم ملحوظ، والمخيّلة عند الشاعر الحديث بدوره حديثة تجاوزت تهالكها، وهي تحت ضوء الحاضر. وربّما إعلانه أنّ الشعر العربيّ أفضل من أيّ وقت مضى، وأنّ كلّ الكلام الكربلائيّ عن انحدار الشعر وتحطّمه هو كلام مَن يرى الماضي جثّة هامدة، يحتمل الاختلاف ولا سيّما أنّ هناك مزاعم بتقهقر الشعر واقعيّاً وتراجعه أمام تصدّر فنون أدبيّة أخرى واجهة الاهتمام والمتابعة والتأثير.
كان لافتاً إطلاق الشاعر لكثير من الأسئلة في فضاء التخمين والتشكيك وإعلانه أنّه لا يملك عنها أجوبة، يبقيها معلّقة ككائنات المنافي نفسها. ومن تلك الأسئلة: لماذا يحتاج الشعراء إلى الأسطورة والتراث؟ لماذا نعود إلى الوراء لنكتب شعراً جديداً؟ هل يمكن للشعراء أن يهدموا الجدران بين أزمنة الكتابة؟ كيف يمكن ابتكار وارتكاب شيء جديد يمنح الشعريّة معناها ويضفي عليها أبعاداً جديدة كلّ مرّة؟ كيف يمكن تفكيك جغرافيّة القصيدة؟ هل يمكن للشاعر أن يترجم الحياة في قصيدة؟ ماذا عن قدره الشخصيّ كـ"بريطانيّ"؟ هل لقصيدته حقّ على هواء لندن؟ كيف يمكن للقارئ العربيّ التواصل مع الخبرات المضمونة في القصيدة؟ أليس هذا منفى آخر للشاعر؟ أليس منفى للشعر نفسه في الشعر؟
وبالغوص في هموم الواقع السوريّ المَعيش تساءل: هل تمّ التعبير عن الحريق الذي يجتاح بلاد الشام في الأدب والثقافة؟ أين دور النخب المثقّفة الأوروبيّة والسؤال الأخلاقيّ الواجب؟ لماذا تركونا وحدنا كما هتف المسيح ذات يوم..؟ كيف يجري ما يجري دون أن يكون لديهم القدرة على رفع الصوت وفضحه؟ كيف يمكن أن تمرّ المجازر المقترفة بحقّ السوريّين على الضمير الأخلاقيّ الأوربيّ؟ أمام تفشّي المجازر والقتل والدمار والموت الوحشيّة والعنف نتساءل أيّة قصيدة سنكتب؟