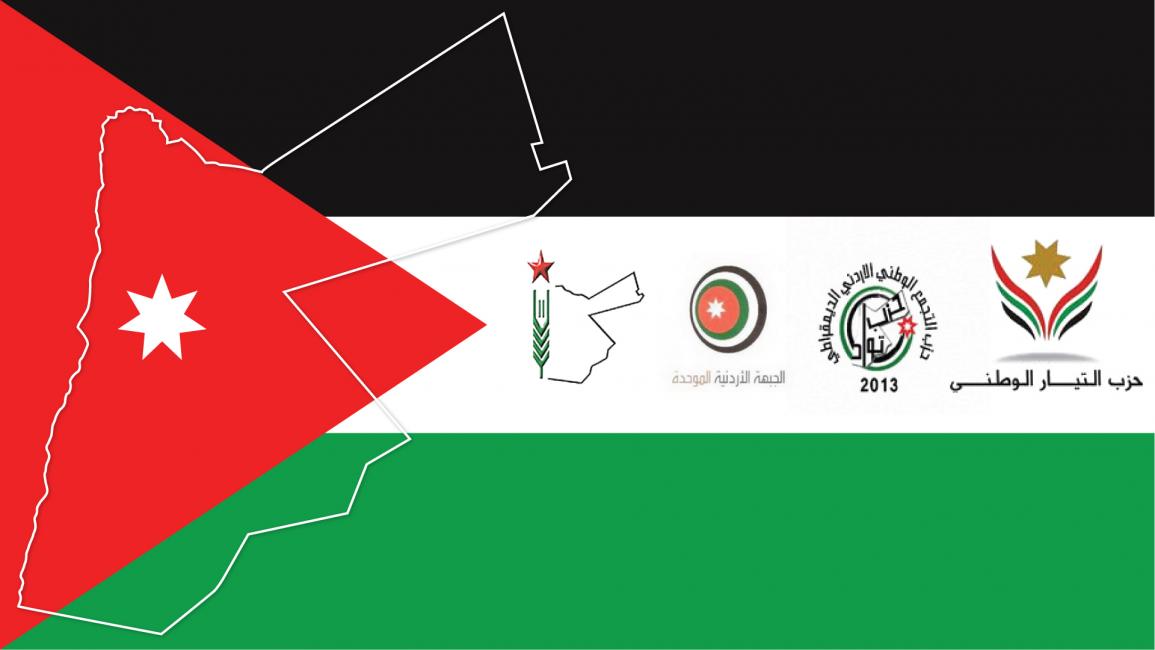15 سبتمبر 2023
أزمة الليبرالي والوطني الأردني والبحث عن مخرج
بين جدل وطني حول عاصمة جديدة، وعلاقات الأردن مع أشقائه العرب، وموقفه من الأزمات العربية، والمصالحة الفلسطينية وتجاهله الكامل فيها، وقفز بعض دول الخليج من فوقه نحو إسرائيل، والحديث اليومي الصاخب سياسياً بشأن أداء الحكومات. هناك نخب تُعلن خروجها من المشهد، ويأسها من الإصلاح، وثمّة من يبقى ويريد البقاء ويمتطي صهوة جواد الدفاع عن المصير الأردني بشكل عجيب. وهو ما تجسد بظهور حزبٍ أطلق عليه "اسم فرسان الشرق"، وصدّر بيانه الأول بسقف عالٍ، ونهج مخالفٍ لطبيعة منتسبيه، وجُلهم متقاعدون عسكريون ووجهاء تقليديون، من المعروفين تاريخياً بـ"عظام الرقبة".
في الخريطة النخبوية الأردنية، ثمّة وجهاء وقادة وزعماء ينتمون لتكوينات أواخر العصر العثماني. فالأجيال أحياناً تتعاقب في الوزارات وسلم الوجاهة الاجتماعية والوظائف، والتمثيل الشعبي ومجلس الأعيان. وإلى حدّ ما، كان التمثيل البرلماني الأردني مؤثراً وأداة تغيير وطني، والاستمرار في الانتخابات عبر ثمانية عشر مجلسا، أدخل نواباً من خلفيات ومجاميع اجتماعية مختلفته، قوّضت إرث الإقطاع ومخرجات نيابة العشائر التي تعد أول مؤسسةٍ قامت في الأردن بعد وصول الملك المؤسس إلى الأردن في 1921.
كان ذلك التغيير بارزاً عام 1956 بوصول الحزب الوطني الاشتراكي إلى الحكم بزعامة سليمان النابلسي، والذي لحقه إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، فكان البلد يقفز إلى زمن جديد، لكن المحيط العربي كان يطلب رأس الحكم، ويريد تطويعه، والحسين رحمه الله كان فتياً في الحكم، والأحزاب طامحة، لكن البلد شهد حداثةً سياسيةً فريدة مدة وجيزة مع حكومة النابلسي التي استمرت ستة أشهر، ولاحقاً اكتشفت الدولة أن العودة عن تلك اللحظة منجاة بقاء
لها، فأقيلت الحكومة، وفتح سجن الجفر لاستقبال الزوار. آنذاك، عادت الدولة إلى جرارها القديمة، باعتبار من فيها مضموني الولاء والطاعة. واستمر الأمر عقوداً، وتكرّس بعد أحداث أيلول 1970، وهي حقبة حرجة وخطرة، تبعها اغتيال رئيس الوزراء في حينه، وصفي التل.
قبل ذلك، بدأ الأردن عام 1962 بإنشاء جامعته، وبقية مؤسساته: البنك المركزي والجمعية العلمية الملكية والخدمات الطبية وغيرها، كان الزمن صعباً والمال شحيحاً، لكن كان هناك رجال بناء وعزم لا يطاوله فساد، فحولوا الأزمات إلى فرص وبدلوا خيار الحكم، من الديمقراطية والانفتاح السياسي إلى مقولة التنمية، وهو أمر نهجت به دول كثيرة، فاقتنع الناس العاديون بذلك، وأقنع الحسين الشعب بأن الهدف هو الإنسان من باب التعليم والصحة والخدمات، وظلت النخب تتململ، وتريد حياة حزبية وديمقراطية، وليس مجرد خطط تنمية وتشييد مبان. ولم يأبه الحسين لنقد معارضيه بمقولة التبعية للغرب وما شابه، بل ظلّ مصراً على المضي إلى الأمام، لكن النخب والأحزاب تعطل دورها منذ 1956 وحتى مفتتح التسعينات.
سنحت فرصة، ذهبية لذلك عام 1989، تعامل معها الحسين بذكاء، وأدرك أن رياح التغيير قادمة، والعالم مفتوح عليها، وهو ما حدث لاحقاً في انهيار الاتحاد السوفييتي، وبدت عودة الحياة الديمقراطية ممكنة، وأجريت انتخابات نظيفة، قدمت فيها القبائل والعشائر قاعدة الحكم وخط دفاعه الأول، أفضل ما لديها من سياسيين ومتعلمين ومعارضين في آن واحد. وجاءت بنخب جيدة، لكن الأمر لم يطل، فتمّ الانكفاء عن ذلك بعد 1994.
صعد بعضهم في التمثيل السياسي لاحقاً بجهود فردية، وبرغبة أحياناً من الدولة في إظهار شيء من الحياد، وأفضلية وجود صوت مختلف، لإيجاد نخب بديلة للتي كانت في طريقها إلى الاندثار، ولتخفيف نقد مقولة: "ابن البيك بيك"، لكن صفاءً كاملاً مع التقدميين لم يحدث، وهو ما تعزّز باستقالة القوميين من حكومة طاهر المصري عام 1991؛ احتجاجاً على خيار السلام، ما أزعج الحكم، وعزّز حضور النخب التقليدية البيروقراطية والقبلية ذات الصبغة الولائية.
هذا ما حدث في غير مكان عربي، فالدولة الوطنية عربياً تحالفت مع كل النخب المورثة عثمانياً وانتدابياً، أو استقطبتها، وحتى كبرت الدولة وتمأسست وتضخمت، صار أحفاد هؤلاء فاعلين فيها، أو نافذين في المصائر، ومن رحم طبقة الوجهاء التقليديين، أو من أبناء المعارضة واليسار، ولد جيل ثالث، منتمٍ للغرب. تلقى تعليمه هناك، وتشبع بالأفكار الغربية، وعاد إلى البلد ونظّم أمور العائلة وفتح الشركات، وحولها إلى مؤسسات. وكان قسم منهم من خلفياتٍ يسارية، فمنحتهم المواقف السياسية الاستقلالية الاقتصادية وحتمية التوجه إلى العمل الخاص، ما وفّر لهم فرصة ممارسة النقد والصعود إلى الضوء، بفعل مقولة أن الحكم يستقطب المعارضة أحياناً، وبفعل إدراكهم منجزهم ووطنيتهم أحياناً أخرى، كما أنهم لا يشكلون عبئاً على الحكم، ولا يطمحون إلى مناصب، ولا يريدون وظائف لأبناء قراهم، فثمّة تحلل من أعباء النخبوي التقليدي الذي يُكلفه التمثيل الجهوي والوجاهي عبء ضرورة حمل مطالب قاعدته الاجتماعية للحكم، والسعي إلى أجلها وتنفيذها.
هذه الوجوه: التقليدي الحامل عبء العشيرة وأفرادها، والبيك المتقاعد والذي ما زال طمّاحا، والليبرالي المتوثب، والبيروقراطي العتيد، والإسلامي المحافظ، والشيخ المعمم، وداعية التقنية، كلها موجود بقياس ما، ومؤثرة اليوم في البلد بصيغ عدة. لكن النخب الليبرالية تبدو أكثر حضوراً، بحكم ثروتها وعلاقاتها ونفوذها تارة، وبحكم مسيرتها الوطنية النضالية تارة أخرى. وهي تسعى إلى تشكيل وتغيير وتحديث سياسي وفق رؤاها، أو ما تعتقد أنه لازم وواجبٌ لتطوير البلد.
مقطع آخر من هذه الفئة الليبرلية، يظهر في قسمٍ لم يسافر ويتعلم غرباً، أو يملك الثروة، بل ممن تطلّعوا إلى إمكانية الكسب من الانتماء للنادي الليبرالي، وهؤلاء المتعاطفون من الراغبين في الـتأثير الإيجابي أو الصعود في دائرة الاهتمام، وهم من خلفياتٍ ريفية، ورفقة الصالون الليبرالي الضاغط على الحكم بوجوب إصلاح البلد وتطويره، قد تتيح لهم البقاء في الواجهة.
هذا التشكل الليبرالي الراهن، أردنيا مشكلته، في قسمٍ منه وليس كله، أنه معزول عن تاريخ البازار الوطني الأردني، بل هو ابن زمن الموجة الأميركية، وزمن الفساد والرشوة واختراق الدول. لكن لا يجوز اتهام أحد بوطنيته من طرف ليبرالي أو غيره، فالكل أضحى منتفعاً من الحكم والدولة. وما يدور من تخوين لبعض رموز التيار الليبرالي غير مقبول.
لنعد إلى الاقتصاد في الأردن، والذي لم يتشكل فعلياً إلا بعد عام 1950. آنذاك يسهل رصد من يملك المال، لكنهم كانوا وطنيين ودعاة دولة واستقلال وطني. في ذلك الزمن، يمكن رصد يوسف السكر وخليل السالم وصالح المعشر وصبري الطباع وسعيد أبو جابر وتوفيق قطان ومحمد علي بدير وعبد الحميد شومان ولاحقاً إيليا نقل ونقولا وفائق الصايغ ونقولا أبو خضر وغرغور وغيرهم ممن أسهموا في اقتصاد البلد وتحديثه.
اليوم سياسات المصالح تمتحن سياسات الحقوق والتحديث في الأردن، تسير بعض الأصوات إلى رهان غير محسوب. ثمّة نخب وطنية غاضبة، وثمّة أصوات ليبرالية طامحة أيضاً، فتبدو مقطوعة النقد بنغم ناقد للحكم بشكل غير مسبوق وغير متسق. ولذلك، تجد من ينتقدها من حلفاء الدولة. وحجة الناقدين، كما كانت حجة الحزبيين في الدول الشمولية، أن كل من يطالب بالديمقراطية عميل للغرب. لذلك يُنعت الليبراليون والوطنيون معهم أحياناً من خصومهم بأنهم ينتقدون، لكي ينالوا رضى السفارة الأميركية، علماً أن بعضهم صادق ووطني ومخلص، ولدى بعضهم طموح. وأسهل التهم دوماً مقولة الأجندات الخارجية.
بيد أن الوطنية البيروقراطية أيضا في أزمة، وتجد من يواجهها، أنها انتفعت دهراً من الدولة، والآن تخلت عنها، بالتالي الوطنية التقليدية أقرباء الحكم وأصفيائه عقودا، والليبرالية المتحمسة، تبدوان اليوم في أزمة مشتركة في مواجهة عدم الجدية بالإصلاح الذي تأخر، كما قال الوزير والسفير السابق، مروان المعشر، سابقاً ومراراً.
نعم الوطنية الأردنية اليوم في أزمة، أزمة خطاب وأزمة تشخيص وأزمة حضور، أخذ بعض رموزها من نخب الحكم إلى الملل ونفاد الصبر. لكن هل يعتبر هذا انتصاراً لليبراليين؟ وهل يعني حل حزب التيار الوطني الذي يتزعمه البيروقراطي العتيد، عبد الهادي المجالي، نعياً مبكراً للوطنية الأردنية ورفع الرايات؟ أم أن مفهوم الوطنية التي فهمها المؤسسون الأوائل في المؤتمر الوطني الأول تعرّضت لجملة انزياحات؟ ولا صلة لها اليوم بما يحدث ومن يمثلها.
التزام الأردن في الإصلاح والتحديث السياسي هو المخرج، وهو الطريق التي يجب أن لا يحيد عنها، ولا سبيل لاستعادة الجمهور إلا بمزيد من سياسات التحديث، ومحاربة الفساد، والعدالة بين الناس العاديين الذين لا يعنيهم كثيراً حل حزب، أو إطلاق مبادرة أو الوصول إلى دولة مدنية أو غيرها، فما يعنيهم في عيشهم شيء أبعد من ذلك، وهو أمر لا يُطرح في جدالات النخب كثيراً. وعندما يحدث التحديث السليم، سيكون من المفيد العمل الحزبي، وسيكون من المفيد البدء بمرحلة جديدة. صحيحٌ أن الإقليم ضاغط، لكن في وسع الأردن تحصين جبهته الداخلية بشكل أفضل، والبناء الوطني حتى في أحلك الظروف.
الحكم في الأردن بالتأكيد غير سعيد اليوم بظروف البلد، لكن خياراته ممكنة، والبديل واضح، ومختصر، وهو الشعب أو التقاط الريح، هذا ما عمله الملك الحسين مرات. فكلما ضاقت عليه الدنيا، عاد إلى الشعب، الإصلاح أو التنمية، أو بتمرين ديمقراطي، أو باختراق سياسي في محاور علاقاته مع العرب والغرب، وكان دوماً يربح شعبه وسمعته.
في الخريطة النخبوية الأردنية، ثمّة وجهاء وقادة وزعماء ينتمون لتكوينات أواخر العصر العثماني. فالأجيال أحياناً تتعاقب في الوزارات وسلم الوجاهة الاجتماعية والوظائف، والتمثيل الشعبي ومجلس الأعيان. وإلى حدّ ما، كان التمثيل البرلماني الأردني مؤثراً وأداة تغيير وطني، والاستمرار في الانتخابات عبر ثمانية عشر مجلسا، أدخل نواباً من خلفيات ومجاميع اجتماعية مختلفته، قوّضت إرث الإقطاع ومخرجات نيابة العشائر التي تعد أول مؤسسةٍ قامت في الأردن بعد وصول الملك المؤسس إلى الأردن في 1921.
كان ذلك التغيير بارزاً عام 1956 بوصول الحزب الوطني الاشتراكي إلى الحكم بزعامة سليمان النابلسي، والذي لحقه إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، فكان البلد يقفز إلى زمن جديد، لكن المحيط العربي كان يطلب رأس الحكم، ويريد تطويعه، والحسين رحمه الله كان فتياً في الحكم، والأحزاب طامحة، لكن البلد شهد حداثةً سياسيةً فريدة مدة وجيزة مع حكومة النابلسي التي استمرت ستة أشهر، ولاحقاً اكتشفت الدولة أن العودة عن تلك اللحظة منجاة بقاء
قبل ذلك، بدأ الأردن عام 1962 بإنشاء جامعته، وبقية مؤسساته: البنك المركزي والجمعية العلمية الملكية والخدمات الطبية وغيرها، كان الزمن صعباً والمال شحيحاً، لكن كان هناك رجال بناء وعزم لا يطاوله فساد، فحولوا الأزمات إلى فرص وبدلوا خيار الحكم، من الديمقراطية والانفتاح السياسي إلى مقولة التنمية، وهو أمر نهجت به دول كثيرة، فاقتنع الناس العاديون بذلك، وأقنع الحسين الشعب بأن الهدف هو الإنسان من باب التعليم والصحة والخدمات، وظلت النخب تتململ، وتريد حياة حزبية وديمقراطية، وليس مجرد خطط تنمية وتشييد مبان. ولم يأبه الحسين لنقد معارضيه بمقولة التبعية للغرب وما شابه، بل ظلّ مصراً على المضي إلى الأمام، لكن النخب والأحزاب تعطل دورها منذ 1956 وحتى مفتتح التسعينات.
سنحت فرصة، ذهبية لذلك عام 1989، تعامل معها الحسين بذكاء، وأدرك أن رياح التغيير قادمة، والعالم مفتوح عليها، وهو ما حدث لاحقاً في انهيار الاتحاد السوفييتي، وبدت عودة الحياة الديمقراطية ممكنة، وأجريت انتخابات نظيفة، قدمت فيها القبائل والعشائر قاعدة الحكم وخط دفاعه الأول، أفضل ما لديها من سياسيين ومتعلمين ومعارضين في آن واحد. وجاءت بنخب جيدة، لكن الأمر لم يطل، فتمّ الانكفاء عن ذلك بعد 1994.
صعد بعضهم في التمثيل السياسي لاحقاً بجهود فردية، وبرغبة أحياناً من الدولة في إظهار شيء من الحياد، وأفضلية وجود صوت مختلف، لإيجاد نخب بديلة للتي كانت في طريقها إلى الاندثار، ولتخفيف نقد مقولة: "ابن البيك بيك"، لكن صفاءً كاملاً مع التقدميين لم يحدث، وهو ما تعزّز باستقالة القوميين من حكومة طاهر المصري عام 1991؛ احتجاجاً على خيار السلام، ما أزعج الحكم، وعزّز حضور النخب التقليدية البيروقراطية والقبلية ذات الصبغة الولائية.
هذا ما حدث في غير مكان عربي، فالدولة الوطنية عربياً تحالفت مع كل النخب المورثة عثمانياً وانتدابياً، أو استقطبتها، وحتى كبرت الدولة وتمأسست وتضخمت، صار أحفاد هؤلاء فاعلين فيها، أو نافذين في المصائر، ومن رحم طبقة الوجهاء التقليديين، أو من أبناء المعارضة واليسار، ولد جيل ثالث، منتمٍ للغرب. تلقى تعليمه هناك، وتشبع بالأفكار الغربية، وعاد إلى البلد ونظّم أمور العائلة وفتح الشركات، وحولها إلى مؤسسات. وكان قسم منهم من خلفياتٍ يسارية، فمنحتهم المواقف السياسية الاستقلالية الاقتصادية وحتمية التوجه إلى العمل الخاص، ما وفّر لهم فرصة ممارسة النقد والصعود إلى الضوء، بفعل مقولة أن الحكم يستقطب المعارضة أحياناً، وبفعل إدراكهم منجزهم ووطنيتهم أحياناً أخرى، كما أنهم لا يشكلون عبئاً على الحكم، ولا يطمحون إلى مناصب، ولا يريدون وظائف لأبناء قراهم، فثمّة تحلل من أعباء النخبوي التقليدي الذي يُكلفه التمثيل الجهوي والوجاهي عبء ضرورة حمل مطالب قاعدته الاجتماعية للحكم، والسعي إلى أجلها وتنفيذها.
هذه الوجوه: التقليدي الحامل عبء العشيرة وأفرادها، والبيك المتقاعد والذي ما زال طمّاحا، والليبرالي المتوثب، والبيروقراطي العتيد، والإسلامي المحافظ، والشيخ المعمم، وداعية التقنية، كلها موجود بقياس ما، ومؤثرة اليوم في البلد بصيغ عدة. لكن النخب الليبرالية تبدو أكثر حضوراً، بحكم ثروتها وعلاقاتها ونفوذها تارة، وبحكم مسيرتها الوطنية النضالية تارة أخرى. وهي تسعى إلى تشكيل وتغيير وتحديث سياسي وفق رؤاها، أو ما تعتقد أنه لازم وواجبٌ لتطوير البلد.
مقطع آخر من هذه الفئة الليبرلية، يظهر في قسمٍ لم يسافر ويتعلم غرباً، أو يملك الثروة، بل ممن تطلّعوا إلى إمكانية الكسب من الانتماء للنادي الليبرالي، وهؤلاء المتعاطفون من الراغبين في الـتأثير الإيجابي أو الصعود في دائرة الاهتمام، وهم من خلفياتٍ ريفية، ورفقة الصالون الليبرالي الضاغط على الحكم بوجوب إصلاح البلد وتطويره، قد تتيح لهم البقاء في الواجهة.
هذا التشكل الليبرالي الراهن، أردنيا مشكلته، في قسمٍ منه وليس كله، أنه معزول عن تاريخ البازار الوطني الأردني، بل هو ابن زمن الموجة الأميركية، وزمن الفساد والرشوة واختراق الدول. لكن لا يجوز اتهام أحد بوطنيته من طرف ليبرالي أو غيره، فالكل أضحى منتفعاً من الحكم والدولة. وما يدور من تخوين لبعض رموز التيار الليبرالي غير مقبول.
لنعد إلى الاقتصاد في الأردن، والذي لم يتشكل فعلياً إلا بعد عام 1950. آنذاك يسهل رصد من يملك المال، لكنهم كانوا وطنيين ودعاة دولة واستقلال وطني. في ذلك الزمن، يمكن رصد يوسف السكر وخليل السالم وصالح المعشر وصبري الطباع وسعيد أبو جابر وتوفيق قطان ومحمد علي بدير وعبد الحميد شومان ولاحقاً إيليا نقل ونقولا وفائق الصايغ ونقولا أبو خضر وغرغور وغيرهم ممن أسهموا في اقتصاد البلد وتحديثه.
اليوم سياسات المصالح تمتحن سياسات الحقوق والتحديث في الأردن، تسير بعض الأصوات إلى رهان غير محسوب. ثمّة نخب وطنية غاضبة، وثمّة أصوات ليبرالية طامحة أيضاً، فتبدو مقطوعة النقد بنغم ناقد للحكم بشكل غير مسبوق وغير متسق. ولذلك، تجد من ينتقدها من حلفاء الدولة. وحجة الناقدين، كما كانت حجة الحزبيين في الدول الشمولية، أن كل من يطالب بالديمقراطية عميل للغرب. لذلك يُنعت الليبراليون والوطنيون معهم أحياناً من خصومهم بأنهم ينتقدون، لكي ينالوا رضى السفارة الأميركية، علماً أن بعضهم صادق ووطني ومخلص، ولدى بعضهم طموح. وأسهل التهم دوماً مقولة الأجندات الخارجية.
بيد أن الوطنية البيروقراطية أيضا في أزمة، وتجد من يواجهها، أنها انتفعت دهراً من الدولة، والآن تخلت عنها، بالتالي الوطنية التقليدية أقرباء الحكم وأصفيائه عقودا، والليبرالية المتحمسة، تبدوان اليوم في أزمة مشتركة في مواجهة عدم الجدية بالإصلاح الذي تأخر، كما قال الوزير والسفير السابق، مروان المعشر، سابقاً ومراراً.
نعم الوطنية الأردنية اليوم في أزمة، أزمة خطاب وأزمة تشخيص وأزمة حضور، أخذ بعض رموزها من نخب الحكم إلى الملل ونفاد الصبر. لكن هل يعتبر هذا انتصاراً لليبراليين؟ وهل يعني حل حزب التيار الوطني الذي يتزعمه البيروقراطي العتيد، عبد الهادي المجالي، نعياً مبكراً للوطنية الأردنية ورفع الرايات؟ أم أن مفهوم الوطنية التي فهمها المؤسسون الأوائل في المؤتمر الوطني الأول تعرّضت لجملة انزياحات؟ ولا صلة لها اليوم بما يحدث ومن يمثلها.
التزام الأردن في الإصلاح والتحديث السياسي هو المخرج، وهو الطريق التي يجب أن لا يحيد عنها، ولا سبيل لاستعادة الجمهور إلا بمزيد من سياسات التحديث، ومحاربة الفساد، والعدالة بين الناس العاديين الذين لا يعنيهم كثيراً حل حزب، أو إطلاق مبادرة أو الوصول إلى دولة مدنية أو غيرها، فما يعنيهم في عيشهم شيء أبعد من ذلك، وهو أمر لا يُطرح في جدالات النخب كثيراً. وعندما يحدث التحديث السليم، سيكون من المفيد العمل الحزبي، وسيكون من المفيد البدء بمرحلة جديدة. صحيحٌ أن الإقليم ضاغط، لكن في وسع الأردن تحصين جبهته الداخلية بشكل أفضل، والبناء الوطني حتى في أحلك الظروف.
الحكم في الأردن بالتأكيد غير سعيد اليوم بظروف البلد، لكن خياراته ممكنة، والبديل واضح، ومختصر، وهو الشعب أو التقاط الريح، هذا ما عمله الملك الحسين مرات. فكلما ضاقت عليه الدنيا، عاد إلى الشعب، الإصلاح أو التنمية، أو بتمرين ديمقراطي، أو باختراق سياسي في محاور علاقاته مع العرب والغرب، وكان دوماً يربح شعبه وسمعته.