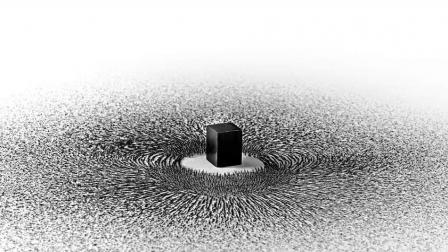في العقود الثلاثة الأخيرة، بعد سقوط جدار برلين و"آخر قلعة للستالينية في أوروبا"، أصبح "أدب السجن" في العالم أغنى مع ما نُشر من روايات في ألبانيا التي كانت نموذجاً حيّاً لـ"الغولاغ" (اسمٌ كان يطلق على معسكرات الاعتقال السوفييتية) خلال 1945 - 1990، وما تُرجم منها إلى اللغات الأوروبية حتى 2011، حين ظهر تدفُّق جديد من الروائيّين السوريّين الذين أغنوا برواياتهم هذا النوع من الأدب.
يكفي هنا للدلالة على ماذا كان يعني السجن، أن نستذكر مصير الكاتبة الألبانية محسنة كوكالاري (1917 - 1983)، التي كانت أوّلَ ألبانية درست الأدب في الخارج (إيطاليا)، وعادت بروح جديدة، لتكون أوّل كاتبة بعد أن نشرت أول مجموعة قصصية عام 1941 بعنوان "كما تقول أُمّي العجوز"، ثم "حول النار" في 1944، وفي السنة ذاتها شاركت في تأسيس "الحزب الاشتراكي الاجتماعي" الذي أصبح يُعتبَر حزباً معادياً بعد وصول "الحزب الشيوعي" إلى السلطة عام 1945؛ ففي كانون الثاني/ يناير 1946، اعتُقلت وحُكم عليها بالسجن عشرين سنةً، باعتبارها من "أعداء الشعب". وبعد أن قضت 18 سنة في أسوأ سجن (بوريل)، نُفيت إلى بلدة رشن النائية في شمال ألبانيا، لتُجبَر على العمل هناك عاملةَ نظافة مع حرمانها الكتابة والنشر تحت الرقابة اليومية، إلى أن مرضت بالسرطان ورحلت في الرابع عشر من آب/ أغسطس 1983 دون أن تلقى أية رعاية طبيّة مناسبة.
بعد انتهاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة في 1990، برز فيضٌ من أدب المذكّرات والروايات عن الجانب المظلم للنظام، والمتمثّل في عالم السجن وما بعد السجن (النفي وحرمان الحقّ في النشر في الصحف ودور النشر التي كانت كلّها بيد النظام الحاكم) في الوقت الذي كانت فيه ألبانيا "قلعة مغلقة" دون تلفزيون واتصال هاتفي مباشر مع العالم. وفي مثل هذا الوضع، كان يُمكن كاتبةً شابة واعدة مثل محسنة كوكالاري أن يُمحى اسمها من الذاكرة لدى الجيل الذي وُلد بعد 1945، وألّا يجرؤ أحد على ذكرها أو استذكارها، إلى أن جاء النظام الديمقراطي الجديد ليمنحها وسام "شهيدة الديمقراطية" في 1993، ويعيدها إلى الحياة/ الذاكرة الجماعية من جديد.
من الجيل الجديد المخضرم لدينا بسنيك مصطفى (1958)، الذي انشقّ عن النظام مبكراً، وأصبح من قادة المظاهرات التي انطلقت في ألبانيا خلال 1989، ومن مؤسّسي أوّل حزب غير شيوعي، وهو الحزب الديمقراطي الذي وصل إلى الحكم بعد أوّل انتخابات حرّة. وقد سمحت له الدراسة في قسم اللغة الفرنسية وآدابها في "جامعة تيرانا" بأن يتعرف إلى ثقافة مغايرة، لكن مصير الخرّيج كان يحدده الحزب الحاكم. وهكذا اشتغل أوّلاً في التعليم، ثم في "صوت الشعب"، صحيفةِ "الحزب الشيوعي"، ثم عمل مترجماً في "معهد الدراسات الماركسية اللينينية" (1983 - 1988)، لينتقل بعدها إلى "اتحاد الكتّاب" ويتولّى رئاسة تحرير "الجريدة الأدبية".
وبعد مشاركته الفعّالة في المظاهرات وأوّل حزب للمعارضة، أصبح في 1991 عضواً في أوّل برلمان ديمقراطي، وفي 1992 أصبح أوّل سفير لألبانيا الديمقراطية في باريس. في 2005 أصبح وزيراً للخارجية، ليستقيل في 2007 من الحكومة و"الحزب الديمقراطي" احتجاجاً على ما آل إليه الحال مع رفاق الأمس. أصدر أوّلَ مجموعة شعرية عام 1978 بعنوان "موتيفات فرحة"، ثم صدرت له عدّة مجموعات شعرية وروايات، وصولاً إلى رواية "حلم الدكتور" في 2017 التي سخر فيها من الطبقة السياسية الجديدة في ألبانيا، والتي تولّت الحُكم بعد تفكُّك "الحزب الشيوعي".
 من رواياته أيضاً "قصّة صغيرة" التي صدرت في تيرانا عام 1995، ثم صدرت في طبعات أُخرى في ألبانيا ومكدونيا الشمالية وتُرجمت إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية أخيراً (2018). وفي مقارنة بغيره من الروائيّين الذين سُجنوا وكتبوا عن تجربتهم في السجن، لا يتحدّث مصطفى في هذه الرواية عن تجربة فردية أو عن تجربة جيل 1945 - 1990، بل عن تجربة جمعية أو عن تجربة ثلاثة أجيال في ألبانيا خلال القرن العشرين، مع التركيز بطبيعة الحال على جيل 1945 - 1990، لنفهم منها تجربة السجن من جانبَين (السجناء والسجّانون)، ومن الأصل: النظام الذي هو في جوهره ديكتاتورية مستمرّة بأسماء مختلفة.
من رواياته أيضاً "قصّة صغيرة" التي صدرت في تيرانا عام 1995، ثم صدرت في طبعات أُخرى في ألبانيا ومكدونيا الشمالية وتُرجمت إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية أخيراً (2018). وفي مقارنة بغيره من الروائيّين الذين سُجنوا وكتبوا عن تجربتهم في السجن، لا يتحدّث مصطفى في هذه الرواية عن تجربة فردية أو عن تجربة جيل 1945 - 1990، بل عن تجربة جمعية أو عن تجربة ثلاثة أجيال في ألبانيا خلال القرن العشرين، مع التركيز بطبيعة الحال على جيل 1945 - 1990، لنفهم منها تجربة السجن من جانبَين (السجناء والسجّانون)، ومن الأصل: النظام الذي هو في جوهره ديكتاتورية مستمرّة بأسماء مختلفة.
فنّياً، يعتمد مصطفى على سردية متعدّدة الروايات والشخصيات؛ فلدينا هنا شخصيّتان رئيسيّتان (بارذيل هوتا وليندا هيدي) من أُسرتَين لهما تجارب مع السجن والسجناء والسجّانين، يحب واحدهما الآخر ويتزوّجان ثم يختبران بنفسيهما هذه التجربة من الداخل والخارج. كلُّ واحد يروي "القصة الصغيرة" من معايشته الخاصة، ثم لدينا شخصية الصحافي أندريا بوديتسي الذي يتحمّس لكتابة رواية وينقل لنا بعض الصفحات من مشروع هذه الرواية. وبما أنّ امتداد "القصّة الصغيرة" يشمل ألبانيا في القرن العشرين، فلدينا هنا شخصياتٌ تمثّل العهد العثماني الآفل (حافظ باشا)، والعهد الإيطالي الفاشي (1939 - 1943)، وشخصية رئيسية أُخرى تمثّل السجّان (حكمت هيدي) الذي بقي سجّاناً وفيّاً للنظام الحاكم، باعتباره موظَّفاً "يحترم النظام"، ولدينا أيضاً شخصية المجنون (مال المعتوه) الذي ينطق بما لا يجرؤ به الآخرون ويتفوّه بكلمات "حكيمة"، على الرغم من "الجنون" الذي يبدو عليه.
في رواية بارذيل هوتا للقصّة، يتّضح بسرعة من المقدّمة أنّ والدَه عمر هوتا كان ابناً للجدّ أوسو هوتا الذي سُجن في عهد الملك أحمد زوغو (1928 - 1939). ونظراً لأنّ "الحزب الشيوعي" أعلن الجمهورية في 1945 وقدّم صورةً قاتمةً للملكية في الكتب المدرسية والصحافة، فقد أصبح يمجّد "الأبطال" الذين "ناضلوا وسُجنوا" في عهد الملك زوغو، وأصبح في عهد "الديمقراطية الشعبية" ميزات لأبناء هؤلاء "الأبطال" في الدراسة والعمل والمنح... ومن هؤلاء كان عمر هوتا ابن "البطل" أوسو هوتا. لكن تصرُّفَ عمر مع تاريخ كهذا واحتفاء كهذا، كان يحيّر الحفيد بارذيل؛ فقد حرص كثيراً على أن يختفي عن الأضواء، باعتباره "ابن البطل أوسو هوتا" وأن يعيش في الظلّ دائماً. حتى في عمله، في مخزن أحد المعامل، حيث لم يره أحد خارج هذا المخزن، وكان قليل الكلام حتى إنه كان يكتفي بهزّ الرأس للسلام. كأن هذا الاحتفاء الكبير بوالده "البطل" كان يزعجه ويجعله متوتّراً كلّما وجد في مكان ما أحداً يردّد ذكر والده وتاريخه المجيد في "النضال ضد النظام الملكي البائد".
أصبح هذا يلفت نظر الابن بارذيل في طفولته، ولمّا أصبحَ قادراً على الحديث والتعبير عن هذه الحيرة، كان والدُه عمر هوتا يلومه على سبب تجاهله للجدّ أوسو هوتا، ويتركه في حيرة دائمة مع أجوبته: "تعقّل! كلُّ من يصعد بسرعة يقع على رأسه! ليس بالسهل السقوط من فوق!". كانت هذه الأجوبة تُراكِم الضباب فوق رأس الابن بارذيل. ولكي يُقنِع الابنَ أكثر بعدما كبر، كان يقول له إن "الاعتزاز يُمكن أن يجرّ إلى متاعب وحتى إلى السجن". كان يبدو أنَّ الوالد لديه خوف غريزي من السجن في عهد "الديمقراطية الشعبية"، حتى أصبح الخوف من السجن كابوساً في البيت، وخاصة للابن بارذيل الذي كان يعتز بتاريخ العائلة ممثَّلاً بالجد أوسو.
كان موقف الوالد من تاريخ العائلة وسطياً، حيث إنه لم يكن يمجّد ذلك التاريخ، ولم يتخلّ عنه بالمرّة. كان هذا الموقف المتحفّظ يبدو في حديثه للابن والزوجة حين يخرجان كل يوم من البيت: "احرصوا، إذا ذهبتم إلى السجن، لن أزوركم ولن أهتمّ بكم لأعرف إذا بقيتم على قيد الحياة أو متّم!". ومع هذا التهديد اليومي، لم يوضّح لهم في يوم من الأيام مصدر هذا الشعور بالخطر، وماذا يمكن اتخاذه من إجراءات لتفاديه.
في مثل هذا الجو نشأ وكبر بارذيل، ثم تعرّف إلى ليندا وأحبّها وتزوّجها، وكأنه بذلك كان يعارض كلّ ما عمل والده لأجله: أن يبعده عن جوّ السجن. فقد جاء الزواج بليندا ليشكّل ضربة قوية للوالد، لأن السجن كان جزءاً لا يتجزّأ من التاريخ العائلي لزوجته، بل إنّ والد زوجته كان يعمل سجّاناً أو حارساً في السجن، حسب التعبير المحلي في العهد الملكي الألباني، ثم في العهد الإيطالي الفاشي، وأصبح عاراً على الأسرة في العهد الشيوعي الذي كان يعتبر أنّ مشروعية وصوله إلى السلطة ترتبط بنضاله ضد العهدَين المذكورين. لكن قصّة السجن لن تكتمل إلّا مع دخول بارذيل السجن وتعرّفه من الداخل إلى هذا العالم الذي كان والده يريد أن يكون بعيداً عنه، حتى بالكلام عنه أو بالاستماع إلى أحاديث الآخرين عنه.
تجربةُ السجن كانت قاسيةً، خاصّة لبارذيل الذي أحبّ ليندا وتزوّجها رغم سمعة جدّها (حكمت هيدي) السيئة الآن في العهد الشيوعي، ولكنه لم ينعم بحبّه سوى سنة واحدة. في السجن المركَّب (العمل في منجم في ظروف صعبة طوال ثلثَي النهار وقضاء الثلث الأخير للنوم في مهجع سيئ مع ستّين سجيناً بمرحاض واحد مكشوف تنبعث منه الروائح باستمرار) يسمع عن "امتياز" من "الإدارة الحكيمة": السماح للأزواج بقضاء ليلة مع زوجاتهم في "الغرفة المظلمة" التي تقع بعيداً عن القاعة. في سبيل حبّه وشوقه إلى زوجته ليندا، كان على استعداد لأن يُبدي كل الطاعة والقبول بكل الأعمال التي تُطلَب منه لكي يضمن الموافقة على طلبه من وزارة الداخلية بالاستناد إلى توصية من إدارة السجن. فيما بعد يكتشف الحكمةَ من هذا "الامتياز" متمثّلةً بنجاح إدارة السجن في ترويض السجناء، ولكنه كان قد بلع الطعم واستمرّ لكي يتمتّع بليلة واحدة مع حبيبته ليندا.
وفي رواية ليندا للقصة، تتّسع الرؤية حينما تنجح في التعرّف إلى تاريخ جدّها (حكمت هيدي) الذي أصبح كأنه غير موجود، نظراً إلى الرواية الجديدة عنه في العهد الشيوعي. كان حكمت سليل عائلة امتهنت الخدمة العامّة لدى الدولة، ولذلك كانت لا تتدخّل في السياسة، وتعمل "حسب النظام". كان حكمت سجّاناً في السجن الموروث من العهد العثماني، وهو أمرٌ له دلالته، ولكنه كان محترَماً لا يسيء معاملة السجناء ولا يمتنع حين يلتقيه أهلُهم في الطريق إلى بيته عن الحديث معهم وطمأنتهم على صحّة أولادهم، ولكنه لم يكن يوافق على نقل رسائل إليهم، لأنه كان يَعتبر هذا "مخالفاً للنظام".
ومن هنا، حين بدأ الاحتلال الإيطالي لألبانيا في نيسان/ إبريل 1939، هرب السجناء السياسيون (من أعضاء الحزب الشيوعي وأنصاره) وأخذوا معهم جميع السجّانين إلى الجبال المجاورة (معقل المقاومة المسلحة) باستثناء حكمت الذي كان يحسن معاملتهم. بقي حكمت وحده في السجن، بانتظار أن يصل أحد من ممثّلي النظام الجديد لكي يسلّمه السجن "حسب الأصول"، أي بموجب محضَر يشمل تسليم الأسلحة والمفاتيح. تعجّب الضابط الإيطالي الذي وصل إلى السجن من تبرير حكمت الذي "يؤمن بالنظام"، ولذلك طلب منه أن يبقى لـ"يعمل مع النظام" الجديد بعدما أصبحت ألبانيا جزءاً من الإمبراطورية الإيطالية الجديدة.
ولكن دارت الأيام بسرعة وسقطت "ديكتاتورية" موسوليني في خريف 1943 وتكرّر المشهد: سَمح حكمت لكل السجناء السياسيّين بالخروج، وبقي ينتظر من سيأتي باسم "النظام الجديد" لتسلُّم العهدة منه. ونظراً لأنه لم يأتِ أحد، فقد ذهب إلى بيته وبقي ثلاثة أيام قضى معظمَها في النوم. ولكن هذه الأيام الثلاثة أثارت مخيّلة روّاد محل الحلاقة والقهوة، حيث أصبحت تتشكّل وتتضخّم الشائعات والروايات عن تصرُّف حكمت ومصيره. في اليوم الرابع، جاءه للاطمئنان عليه الجنرال السابق في الجيش العثماني حافظ باشا، الذي كان مُعجَباً به وبانضباطه. وما إن بدأ حافظ باشا ينقل له بقلق الإشاعات التي تدور في البلدة والأغاني الشعبية المعروفة التي يحوّلها المجنون مال لكي تصبح سياسية، ومنها واحدة عن حكمت بالذات ومصيره، حتى جاء الصحافي أندريا بوديتسي ليسمع منه أيضاً لكي يُكمل كتابه أو روايته عنه.
في غضون ذلك، مرَّ في جوار البيت مال وهو يغنّي، فدعاه حكمت أيضاً للمشاركة في الجلسة. وعندما سأله الصحافي عمّا رآه من أحلام خلال تلك الأيام الثلاثة التي قضاها في البيت، ردّ حكمت عليه بأنه بالفعل رأى حلماً جميلاً يطلب منه أن يقتله "لكي يكون قرباناً لكتابه الجديد". وما إن سحب مسدّسه حتى قام حافظ باشا، فدفعه حكمت، ولكنَّ الزوجة رأت بسرعة لمعان نصل حافظ باشا يخترق رأس حكمت في اللحظة التي أطلق فيها النار على الصحافي ليرديه قتيلاً. في هذه اللحظة تفوّه المجنون مال بعبارة "حكيمة" كالعادة: "كمان ديكتاتورية أخرى يا حكمت!".
هذه العبارة التي تنبّأت بدكتاتورية أُخرى وصلت إلى الحفيدة ليندا، التي تختم الرواية بكابوسها بعد الليلة التي قضتها مع زوجها في السجن، الذي أصبح يحكمها حول مصير وليدها وما ترغب له أن يكون: سجيناً أو سجّاناً. كانت عائلتها وعائلة زوجها قد عايشتا التجربتين، وفي كلتا الحالتَين يصبح الشخص شبحاً لا يريد لأحد في العهد الشيوعي الجديد أن يذكره، بل حتى يصبح مكروهاً لأجل ذلك من الأولاد. في هذه الحالة تذكّرت نصيحة لإحدى شخصيات الرواية (ميت ريبيتشي الذي يعمل جابياً للضرائب)، وهو ينصح الأولاد الذين يتبعونه بألّا يختاروا في المستقبل مهنته المتعبة، بل نصحهم بأن يكونوا "مقبض الفأس" لكي يبقوا في مأمن، لأنه مهما حدث من تغيرّاتٍ في السلطة، يبقى "مقبض الفأس" في مكامنه. ولذلك تختار ليندا لابنها أن يكون إنساناً من حجر، وبالتالي لا يُعد مهمّاً أن يكون مسجوناً سياسياً أو سجّاناً!
روائي وكثير من السياسة
ولد بسنيك مصطفى Besnik Mustafaj عام 1958 في قرية بشمال ألبانيا، واتسمت تجربته بالمزاوجة الصعبة بين العمل الأدبي والنضال السياسي والعمل العام. شاعر وروائي ودبلوماسي. تخرَّجَ مِن قسم اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة تيرانا. اشتغل أوّلاً في التعليم ثم في صحيفة الحزب الشيوعي "صوت الشعب"، ثم مترجماً في "معهد الدراسات الماركسية اللينينية" (1983 - 1988)، لينتقل بعدها إلى اتحاد الكتّاب ويتولى رئاسة تحرير "الجريدة الأدبية".
كان من أوائل المنضمّين إلى الحراك الديمقراطي في 1990، ومن مؤسّسي "الحزب الديمقراطي" الذي دعا إلى تفكيك الحكم الشمولي. في 1991، أصبح عضواً في أوّل برلمان ديمقراطي في البلاد، وفي 1992 أصبح أوّل سفير لألبانيا الديمقراطية في باريس. في 2005، أصبح وزيراً للخارجية ليستقيل في 2007 من الحكومة و"الحزب الديمقراطي" احتجاجاً على ما آل إليه الحال مع رفاق الأمس.
أصدر أول مجموعة شعرية عام 1978 بعنوان "موتيفات فرحة"، ثم صدرت له مجموعات شعرية وروايات عدّة، من بينها "قصّة صغيرة" (1995)، وصولاً إلى رواية "حلم الدكتور" في 2017 التي سخر فيها من الطبقة السياسية الجديدة في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. تُرجم عدد من أعماله إلى الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية واليونانية.